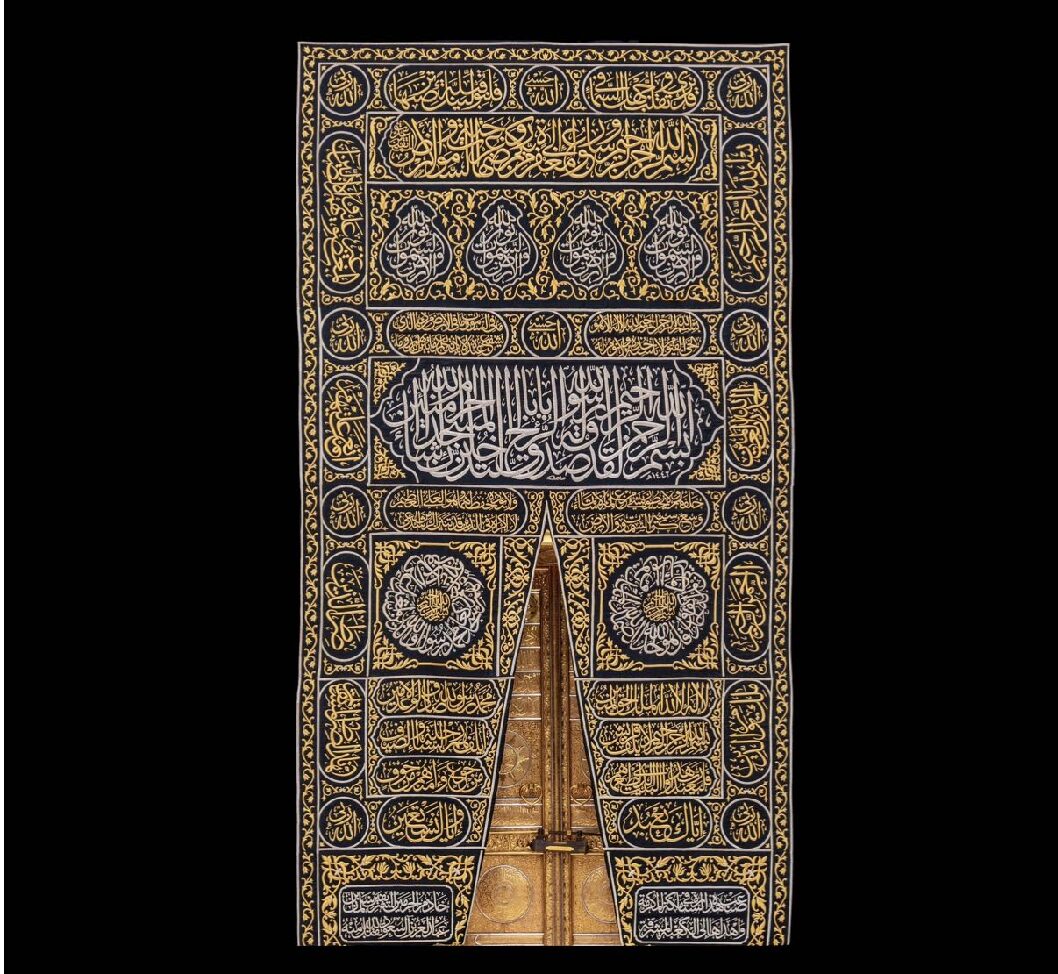إن الخطابة فن من الفنون النثرية ذات الطابع المؤثر، لغايات سياسية واجتماعية ودينية وغيرها، يُعرف على أنه “مجموع قوانين، تعرف الدارس طرق التأثير بالكلام، وحسن الإقناع، وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفات، وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني في الموضوعات المختلفة، وما يجب أن تكون عليه ألفاظ الخطبة، وأساليبها، وترتيبها”.
وقد بدأت الإرهاصات الأولى لهذا الفن في أثينا، مع السفسطائيين الذين كانوا يمارسونها لغايات مكسبية ثم جاء أرسطو ليمنحها بعدًا حجاجيًا، قائمًا على الأدلة والبراهين بهدف الإقناع والإفحام، مع الانتباه لخصوصية كل من الخطيب والمستمع .
والأمر لم يختلف كثيرًا إبان العصر الجاهلي فكانت الخطابة لسان القبيلة، تحمل في طياتها حكمًا ومواعظ، وتتميّز بصبغة ارتجالية منمقة لغويًا وبأسلوب بلاغي رصين، يعتمد على الصور البلاغية والاستهلال المحكم المنبثق من البيئة الاجتماعية والثقافية في ذلك العصر، ولطالما ناسبت الخطبة الموقف الذي قيلت فيه، ففي العصر الجاهلي كانت تُقال بغية الدفاع عن القبيلة والمفاخرة نظرًا لحال القبائل آنذاك من نزاعاتٍ وحروب مستمرة، وهذا ما كان يدعوهم للخطب، كونها موجزة وتحقق الغاية، بالإضافة لخطب الرثاء والعزاء والزواج وغيرها .
مع بزوغ فجر الإسلام، أخذت الخطب بُعدًا جديدًا فلم تُحصر في مجال السياسة أو القبلية بل أخذت الملمح الإسلامي في الدعوة إلى التوحيد ونشر الأخلاق الحميدة وتوجيه المجتمع الإسلامي، فتغيّرت تغيرًا جذريًا من حيث الهدف والأسلوب، إذ اعتمدت على السنة والقرآن في بنائها اللغوي مع بساطة الأسلوب ووضوح الحجّة، وركزّت على القيم والأخلاق، فقد كانت قصيرة ومؤثرة في الوقت ذاته، تتسم بالوقار والجدية بعيدًا عن البلاغة المكلفة أو الزينة اللفظية بل كانت ذات عفوية وتأثير .
أما في العصر الأموي وبسبب النزاعات السياسية والاضطراب الاجتماعي والقبلية، فقد عادت الخطابة لتأخذ شكل هذه الحياة الاجتماعية والسياسية في نصوصها وكلماتها وغايتها التأثيرية .
أما في العصر العباسي وهو العصر الذهبي للأدب العربي والصناعات، ظهرت ألوان أخرى من الكتابات الأدبية، متنوعة الأساليب إلا أن الخطابة ظلّت محافظة على أسلوبها الرصين بالنظرة الفلسفية التي سادت في ذلك العصر .
ثم قل استخدام الخطابة في الحياة العامة إلا أن المحافل الوطنية والاجتماعات الرئاسية والدينية بعثت الروح فيها من جديد، فاتبعت أسلوبًا لغويًا بسيطًا، قائمًا على الوضوح والإقناع البعيد عن التعقيد اللفظي فأصبحت تُلقى في مناسبات رسمية وشعبية ودينية وفي المساجد بطرق تعبيرية مناسبة للجمهور المعاصر .
استطاعت الخطابة أن تحافظ على مكانتها عبر العصور المختلفة، التي كانت وما زالت وسيلة فاعلة للتعبير عن المواقف والدفاع عن المبادئ والتأثير في الجماهير، كما أنها تعد لونًا أدبيًا تكيّف مع متطلبات العصر الحديث، فجمعت بين الأصالة والحداثة، لتبقى فنًا نابضًا بالحياة، حاضرًا في مختلف ميادين التواصل والتأثير .
المرجع :
محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب.