ربط الله الكائنات الحية بطرقٍ للتواصل، فـالنحل يعبرُ بالرقص وأخرى تعبّر بالصوت وبعض الأنواع الحيوانيّة تعبّر بالإيماءات، بينما الإنسان يملك طريقة واحدة وهي اللغة فبها يعبر عن ما شاء كما شاء .
أودع الله في الإنسان العقل وجعله موطنًا للتفكير والتفكُّر وبناءً على بحثه عن طرقٍ للتواصل قامت نشأة اللغة على عدة نظريات، منها المحاكاة والتقليد، حيث اتخذ البشر من الكائنات الحيّة والطبيعة من حوله منهجًا في إنشاء طريقة للتواصل، كتقليد أصوات الحيوانات، أو تقليد أصوات الظواهر الطبيعية من حوله، ومنها استطاع تحريك حباله الصوتية حتى كوّن تراكيب تسمى اللغة، ونظرية أخرى تقول أن اللغة هي اصطلاح بين الناس (تواضع) أي هي مجرد سلسلة بلا بداية ولا نهاية وتتأثر بتأثر البيئة والتغيرات التي تحدث للمجتمع، وأخرى تذهب إلى أن الطفل منذ ولادته يملك جهازًا لغويًا مبرمجًا لاكتساب أي لغة بغض النظر عن البيئة المحيطة به، فهي تنص على أن اللغة قدرة بيولوجية فطرية لدى البشر، تمكنهم من فهم جمل بلغتهم يسمعونها لأول مرة وتركيب جمل لا حصر لها ولا عدد .
بناء على هذه النظريات الثلاث نجد أسبق تعريف للغة عند ابن جني وهو الجامع لهم : “أصوات يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم”، نستشف من تعريف اللغة عند ابن جني خصائص اللغات البشرية دون استثناء، فالأصوات هي هذه الحروف التي تخرج من الحلق نتيجة استنشاق الهواء ثم الزفير، فخروج الحروف في أي لغة تبدأ بالنفس يكون هو العامل الأول في استخراج هذه الأصوات ثم الحنجرة وفيها الحبال الصوتية وبعد ذلك تجويف الفم أو بما يسمى بالمساحة التي بين الحنك الصلب واللين وفيه موقع اللسان وبدوره متخصصًا في إخراج بعض الأصوات الأخرى وهذه العملية النُطقية للأصوات تُحتّم عملية السماع، وبعد ذلك نتطرق لخاصية التعبير وهي غاية اللغات في التعبير عن الأفكار والمشاعر وتبادل المعارف، ثم “كل قوم عن أغراضهم” والمقصود بها الجماعات من الأرض الواحدة الذين يمتلكون لغة واحدة فيعبرون عن كل مكنوناتهم وعلومهم وما يملكون من معارف وفنون بهذه اللغة .
وهناك متجه آخر في تعريف اللغة لدى ابن خلدون، حيث اقتصر في تعريفه عن اللغة بأنها : ” هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها وليس ذلك بالنّظر إلى المفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكيب” يذهب بدوره إلى كون اللغة والقدرة على التعبير هي مهارة يكتسبها الفرد في تفاعله مع مجتمعه مع العلم أنه في الأصل لديه القابلية الفطرية لاكتسابها، فالحكم عن القدرة اللغوية عند الفرد لا يكون خلال كمية المفردات المكتسبة بل خلال قدرة الفرد على وضع هذه المفردات في التركيب الصحيح بعيدًا عن اللحن .
الاختلاف بين تعاريف اللغة المتطرق إليها سابقًا هي الزاوية المُنظر منها، فابن جني اكتفى بأنها أصوات للتعبير مستخدمة بين البشر، وابن خلدون نظر لها من الناحية المعرفية وجودتها التي تكمن في التركيب، وانطلاقًا من هذه الرؤية ؛ أن اللغة تتفاعل مع المجتمع وهي بذلك تشبه الكائن الحي، إذ تتأثر بالمجتمع وتطوره وتؤثر فيه وفي تطوره، فيكمن التأثر في أن المجتمع يضيف إليها تراكيب ومصطلحات جديدة تواكب التطورات الحياتية، فما كان يُستخدم في الماضي بات غير مستخدمًا في عصرنا وما كان غير مستخدم في العصور العربية العريقة بات مشاعًا في العصر الحالي، ككلمة (إنترنت) وغيرها الكثير، بالإضافة إلى تأثيرها في المجتمعات بتعزيز الهوية وتقوية الروابط الاجتماعية وتعد اللغة أداة رئيسة في التعليم وبناء المعرفة، فتصبح بذلك اللغة العامل الأساس في بناء المجتمع وتطوره .
يتقاطع الحديث عن اللغة والمجتمع بالحضارات وتطورها، فيُعرّف الفيروز آبادي في معجمه القاموس المحيط الحضارة أنها “الإقامة في الحضر .. خلاف البادية”، أي أنها المكان المتحضّر التي يملكون فيها سبل المواصلات والتعليم ووفرة العلوم والزراعة ومختلف الابتكارات، فالحضارة هي نتاج قدرة الفرد للاستفادة القصوى من الأرض المملوكة له بزيادة الإنتاجية العلمية والعملية بما يتناسب مع أرضه وثقافته، يعرّف الكاتب فؤاد زكريا الحضارة أنها هي البيئة التي “تشتمل على الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والعلمية والأدبية والدينية من نشاط الإنسان” أي إن لها معنًى جامعًا يضم في داخله مختلف أنواع الثقافات والدراسات التي يبدع بها الإنسان، حيث تنشأ الحضارة بتعاضد الإنسان ومجتمعه بتسخير الأرض لهم وتطوير مختلف العلوم وانتشارها وبذلك تظهر الحضارة، فلا حضارة دون توحد المقصد بين أبناء البيئة الواحدة، فالحضارة تؤثر في شكل الأرض والجغرافيا وفي بناء المجتمع وتماسكه بالإضافة إلى أنها “تتميز بأنها تنفرد دون سائر العلوم بأن لها مع بقية المجالات الأدنى منها علاقة تأثير متبادل”.
فالحضارة ميزة خاصة بالإنسان (إنسانية) والمجتمع، تعدُّ هي مجمع العلوم والفنون ومختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الاستفادة من المعدات الطبيعية المحيطة بالمجتمع وتحويل هذه الأرض الصحرواية إلى أرض متطورة تملك علومًا وفنونًا وإدارة .
هذا المفهوم البسيط عن الحضارة نلاحظ أنها تأتي بمرحلة بعد اللغة، فهي الأساس لبناء هذه الحضارات، فلا تكون حضارة إلا باللغة والتأييد لذلك أن العلوم لا تحفظ إلا باللغة وتطوّر المجتمع يحتاج إلى تكاتفهم ولا يمكنهم التواصل إلا خلال اللغة .
ببداية تجمّع البشر في مختلف الآراضي نشأت اللغة لتبادل الأفكار، وبعد استقرار النّاس في أرض واحدة وتكيّفهم معها أظهروا نُظمًا اجتماعية تعتمد على اللغة لتوثيق العلوم والإدارة والتطور الحاصل في الأرض لحفظها، وبذلك تكون اللغة أسبق من الحضارة .
المراجع :
- ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، ص ٣٣.
- ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، تقديم البروفيسور يوهان، الوراق للنشر، العراق، ٢٠٢٢، ص ٥٧١.
- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، ص ٣٧٦.
- زكريا، فؤاد، الإنسان والحضارة، مؤسسة هنداوي، ٢٠١٨، ص ١٨.
- زكريا، فؤاد، الإنسان والحضارة، ص ٢١.







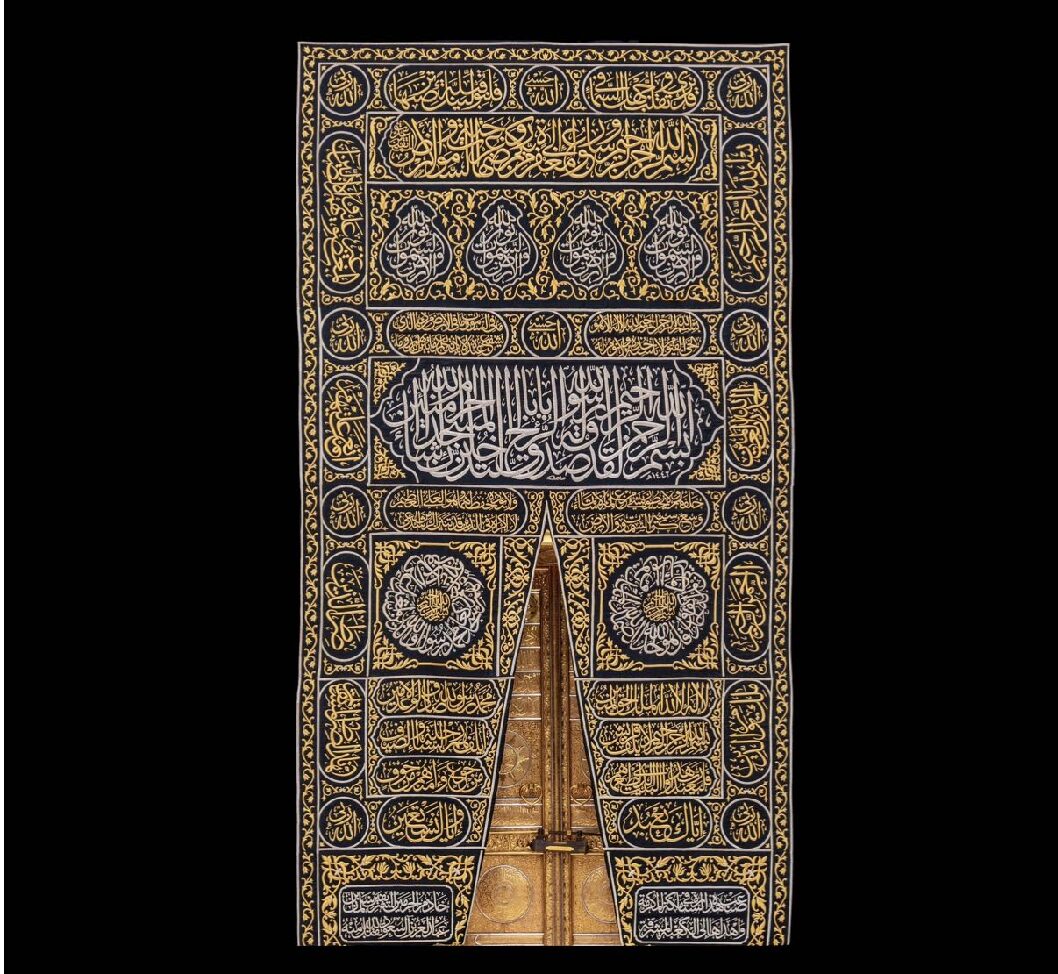


اترك تعليقاً