إن العلاقة بين الحضارة واللغة تعد من الموضوعات الحيوية التي تعكس التفاعل المعقد بين الثقافات المختلفة عبر التاريخ، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي أيضًا تعبير عن الهوية الثقافية، وتاريخ الشعوب، وأفكارهم، فهي وعاء يحمل القيم والمعارف والتقاليد التي تميز كل حضارة عن الأخرى، وفي ذلك يقول فندريس : “في أحضان المجتمع تكونت اللغة”. فلا يمكننا أن نهتم باللغة ونهمل المجتمع الذي تنشأ فيه هذه اللغة أو العكس، فإن العلاقة بينهما ليست تفاضلية، وإنما يمكننا اعتبارها تكاملية، أي أن اللغة امتداد للمجتمع، باعتبارها الوعاء الحامل لثقافة وحضارة وعلوم أي مجتمع .
وبالتالي فإن “للغة وظيفة وارتباطًا كبيرًا بالمجتمع الذي يتكلمها فهي ” أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم” واستخدام اللغة للتعبير عن أغراض المجتمع وحاجاته يجعلها مرآةً تعكس الرُقي، والتطور الحضاري الذي وصل إليه مجتمع معين، فاللغة : ( تحدد الحضارة كما أنها تتحدد بها في الوقت نفسه، فتحددها يكون بأجزاء الحضارة وعلاقتها بالحقائق الحضارية التي تكوّن معها مجموع الحضارة أو بأي اعتبار آخر فهي في الوقت عينه قيد للحضارة ومفتاح لها، فالعلاقة بين اللغة والحضارة علاقة سببية، علاقة تأثير وتأثّر ”[١].
“وتُعرَّف الحضارة لغةً في لسان العرب لابن منظور بأنها الإقامة في الحضر ” [٢] ، واصطلاحاً يعرِّفها ابن خلدون بأنها تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه، من المطابخ والملابس والمباني والفرش، وسائر عوائده وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه [٣].
”ويمكن تعريف الحضارة بأنها منهج فكري يتمثل بانجازات مادية ومعنوية تدل على تطور المجتمع وتقدمه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً “ [٤] . والحضارات لا تبنى إلا على أسس فكرية قوية، واللغة هي أداة بناء هذه الأسس .
تخيل أنك تريد بناء برج شاهق، فهل تستطيع ذلك بدون مواد بناء جيدة ؟ اللغة هي مواد البناء التي نستخدمها لبناء أفكارنا ومعارفنا، وكلما كانت هذه المواد أكثر قوة ومتانة، كان البرج الذي نبنيه أكثر ارتفاعاً ومتانة، لذلك لا يمكن أن تتقدم الحضارة بدون لغة قوية ومتطورة تدعمها .
تلعب الحضارة دورًا رئيسيًا في تأثيرها على اللغة، حيث تؤدي إلى تغييرات في مكوناتها ومعجمها اللغوي، يتجلى هذا التأثير في زيادة ونقصان الألفاظ وفقًا للمستوى الحضاري لمستخدمي اللغة، بالإضافة إلى التخلِّي عن بعض الألفاظ وتطور معانيها وظهور مصطلحات جديدة، ومثال على ذلك تأثر اللغة العربية باللغات الفارسية والتركية خلال العصور الإسلامية، حيث تم إدخال العديد من الكلمات والمصطلحات من هذه اللغات إلى العربية، مما أثرى المفردات العربية وأعطاها طابعًا جديد . “فاللغة نشاط فكري وظاهرة اجتماعية تلازم البشر وتحيا حياتهم أي أنها تسير على سنة التطور الذي يقوِّي البشر، فنجد هناك عصوراً تمتاز بالحضارة والازدهار وأخرى بالتخلف والتقوقع” [٥] .
“واللغة العربية تعتبر أهمَّ خاصية لأمتنا وآكد مُقوِّمٍ لاستمراريتها وأوضحَ دليلٍ على وجودنا، كما يرتبط وجود الأمة العربية بوجود هذه اللغة التي تجمع بين أطراف العالم العربي عموماً . والملاحظ أنَّ هذا الوطن العربي بدأ يبتعد عن لغته؛ ومعروف – تاريخياً – أن من يبتعد عن لغته إنما يفقد ذاته، وفقدان الذات معناه فقدان كل مقومات المجتمع ومن ثَمَّ خسارة خصائص الأمة . وتشـتُّـتُ اللغة يعكس تشتُّتَ أهلها، والانفصال عنها انفصامٌ للرابط الذي يجمع بين مكونات الأمة، والنتيجة الحتمية هي الاندثار التدريجي للهوية التي تمثلها، والاندحار للحضارة التي سُجلت بها، وأسباب الاندحار والاندثار متعاضدة متعاونة بقصد أو من غفلة”[٦] .
وعلى حد تعبير ابن خلدون “قوةُ اللغةِ في أمةٍ تعني استمراريةَ هذه الأمة بأخذ دورها بين بقية الأمم لأن غلبةَ اللغةِ بغلبةِ أهلها، ومنزلتَها بين اللغات صورةٌ لمنزلة دولتِها بين الأمم”[٧]
وتلعب اللغة دورًا أساسيًا في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الحضارات، من خلالها تم توثيق الإنجازات العلمية والفكرية، وبالتالي فإن الحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على التراث الثقافي والمعرفي للأمة، فقد ساهمت اللغة العربية، في نقل العلوم والمعارف من الحضارة الإسلامية إلى أوروبا خلال العصور الوسطى، مما ساعد في إحداث نهضة علمية وثقافية، علاوة على ذلك فإن الفنون والأدب يعكسان أيضًا تأثير اللغة على الحضارات، فالأدب المكتوب بلغة معينة يمكن أن يعبر عن القيم والمعتقدات التي تميز تلك الحضارة، مما يُسهم في تعزيز الهوية الثقافية، وإحدى المؤشرات المهمة على تحضُّر شعب من الشعوب هو علاقته بلغته : كيف ينظر إليها ؟ وكيف يتعامل معها ؟ ثم كم هي قدرات لغته على التعامل مع نمط الحياة السائد؟
ومن ناحية أخرى فقد أشار أ. د. إدريس بوكراع في إحدى محاضراته إلى موضوع مهم وهو” [ اللغة والاستلاب الحضاري ] فأشار إلى أن الاستعمار يعتمد بعد الغزو العسكري على اللغة اعتمادًا كبيرًا في إخضاع الشعوب المستعمرة، إذ باللغة يتمكن من هزيمة الشعوب فكريًا ويتحكم في مصائرها ويفرض عليها نمطه الفكري والحضاري، والأمة حين تُمتَحن بسرقة لسانها تضيع .
وذكر أيضاً التطور اللغوي العام، وهو التغير الذي يطرأ على اللغة كلَّها وبيَّن مظاهره، منها : انتشار اللغة، وذلك بتوسعها المكاني سواء الكلي أو الجزئي، مرتبطًا ذلك بعوامل منها : الهجرة الجماعية، الجوار، الاستعمار، كما أوضح قائلاً بأن اللغة العربية في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية لم تكن لغة العرب وحدهم، بل كانت لغة التعامل الدولي في منطقة شاسعة من العالم، مبيناً أن من مظاهر التغير الذي يطرأ على اللغة، تفرُّع هاته اللغة بتأثير الحضارة، كما قد يقل استعمال اللغة الأم أو يتوقف، هذا ما حدث للغة السامية الأم، التي تفرعت إلى العربية والفينيقية والآرامية والسريانية وغيرها، ومما حدث للاتينية التي تفرعت إلى الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية وغيرها .
وإن اللغات الإنسانية تتفاوت من حيث الأهمية والقيمة تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية والعلمية التي تمر منها المجتمعات الإنسانية، إذ ترتقي اللغة إلى مصاف اللغات العالمية، حين يحصل المتكلمون بها قدراً مهماً من التطور في جميع مناحي الحياة، وتنحط حين يتخلَّف أهلها، وضرب مثلاً بلغات سادت مدة من الزمن وكانت تُعدّْ في وقتها لغات عالمية، كالسريانية والفينيقية” [٨] .
آراء عدد من العلماء حول العلاقة بين اللغة والحضارة
تعد العلاقة بين اللغة والحضارة من أقدم القضايا التي شغلت فكر المفكرين والفلاسفة على مر التاريخ، فكلاهما يشكلان ركيزة أساسية لتطور الأمم وتقدمها، ولعل من أبرز هؤلاء المفكرين ابن خلدون وأفلاطون اللذين قدما رؤى عميقة في هذا الصدد ..
- ابن خلدون : يُعد أحد أبرز المفكرين العرب الذين تناولوا العلاقة بين اللغة والحضارة، في مقدمة كتابه “مقدمة ابن خلدون”، يؤكد أن اللغة هي أداة النطق والتواصل التي تعكس حضارة المجتمع وثقافته، وبها يعبِّر عن أفكاره ومشاعره، ويرى أن اللغة تلعب دورًا محوريًا في تماسك الأمة وتعزيز الهوية والانتماء . وقد ناقش تأثير اللغة على الفكر، وكيف أنها تشكل طريقة تفكير الأفراد، مما ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الفكري والثقافي، كما اعتبر أن تطور الحضارة مرتبط بتطور اللغة، حيث تصبح أكثر قدرة على التعبير عن الأفكار المعقدة والمفاهيم الجديدة .
- أفلاطون : يرى أن اللغة هي مرآة تعكس روح المجتمع، فالكلمات والمعاني التي يستخدمها الناس تعكس قيمهم وعاداتهم وتفكيرهم، وبالتالي فإن تحليل اللغة يمكن أن يكشف لنا الكثير عن طبيعة الحضارة التي أنتجتها .
- فرديناند دي سوسير : يُعد من مؤسسي علم اللغة الحديث، حيث أكد على أن اللغة ليست مجرد مجموعة من الكلمات، بل هي نظام معقد من الرموز التي تُعبر عن الأفكار الثقافية، وقد أشار إلى أن كل لغة تعكس ثقافة معينة، مما يبرز العلاقة العميقة بين اللغة والحضارة .
- توينبي : يرى أن اللغة تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الثقافية والحضارية، فهي وسيلة الاتصال الأساسية التي تربط الأفراد بمجتمعاتهم وتنقل المعرفة والقيم . تسهم اللغة في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهويات، بذلك تعد اللغة عنصرًا أساسيًا لفهم الحضارات وتطورها .
- بروفسور أدوارد سعيد : في كتابه “الاستشراق”، أشار سعيد إلى أن اللغة تُستخدم كوسيلة لتشكيل الصور النمطية والتصورات الثقافية، وبالتالي تلعب اللغة دورًا حاسمًا في بناء الهويات الثقافية والتفاعل بين الحضارات .
- أ. د. إدريس بوكراع : هو أستاذ المعجم والمصطلح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة -أشار إلى ” أن للغة دورا كبيرا في حضارة الأمة، لأنها ركن أساس في هويتها ووسيلة من أهم وسائل توحيدها فكرياً وسياسياً، فهي تتصل بها وتندمج معها اندماجاً، وأضاف قائلا بأن اللغة سر الحضارة، إذ أن الحضارة لا يمكن أن تتحقق دون لغة، لأن اللغة هي التي تمكن الفرد في المجتمع من تنمية معارفه ومهاراته وتيسر له سبيل الاستفادة من أبناء جيله وممن سبقه من الأجيال الماضية، كما أن اللغة توحد الأمة، إذ فوق كونها أداة للتواصل هي عامل رئيس في التنمية الروحية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية . “[٩]
وفي الختام نصل إلى .. أن اللغة والحضارة وجهان لعملة واحدة، فكل حضارة تنتج لغتها الخاصة، وكل لغة تعكس حضارة معينة، وكلما تطورت الحضارة تطورت اللغة أيضًا، مما يؤدي إلى ظهور مصطلحات جديدة تعبر عن الأفكار والمفاهيم الحديثة، ودراسة هذه العلاقة تفتح لنا آفاقًا لفهم أعمق للتاريخ البشري، فتساعدنا لفهم أنفسنا وعالمنا بشكل أفضل .
المصادر والمراجع :
- راضي، فريال مظهر ، اللغة والحضارة، اشراف أ.م.د.إحسان فؤاد عباس، جامعة القادسية، مجلة القادسية في الادب والعلوم التربوية العدد( 1 )، 2019م ، ص125.
- ابن منظور، محمد لسان العرب، بيروت دار صادر، ط 1 ، 2003م، ج 4، حرف الحاء، ص 907.
- ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. درويش جويدي، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، بيروت ، 2000م
- راضي، فريال مظهر ، اللغة والحضارةراضي، فريال مظهر ، اللغة والحضارة ، ص126
- راضي، فريال مظهر ، اللغة والحضارةراضي، فريال مظهر ، اللغة والحضارة ، ص126
- اليوبي، القاسم، اللغة العربية والبحث العلمي الجامعي في الوطن العربي، 2014م ، hespress.com
- ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. درويش جويدي، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية، بيروت ، 2000م
- اللغة والحضارة، مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة CERHSO، المملكة المغربية ، 2009م، herhso.com
- اللغة والحضارة، مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة CERHSO، المملكة المغربية ، 2009م، herhso.com







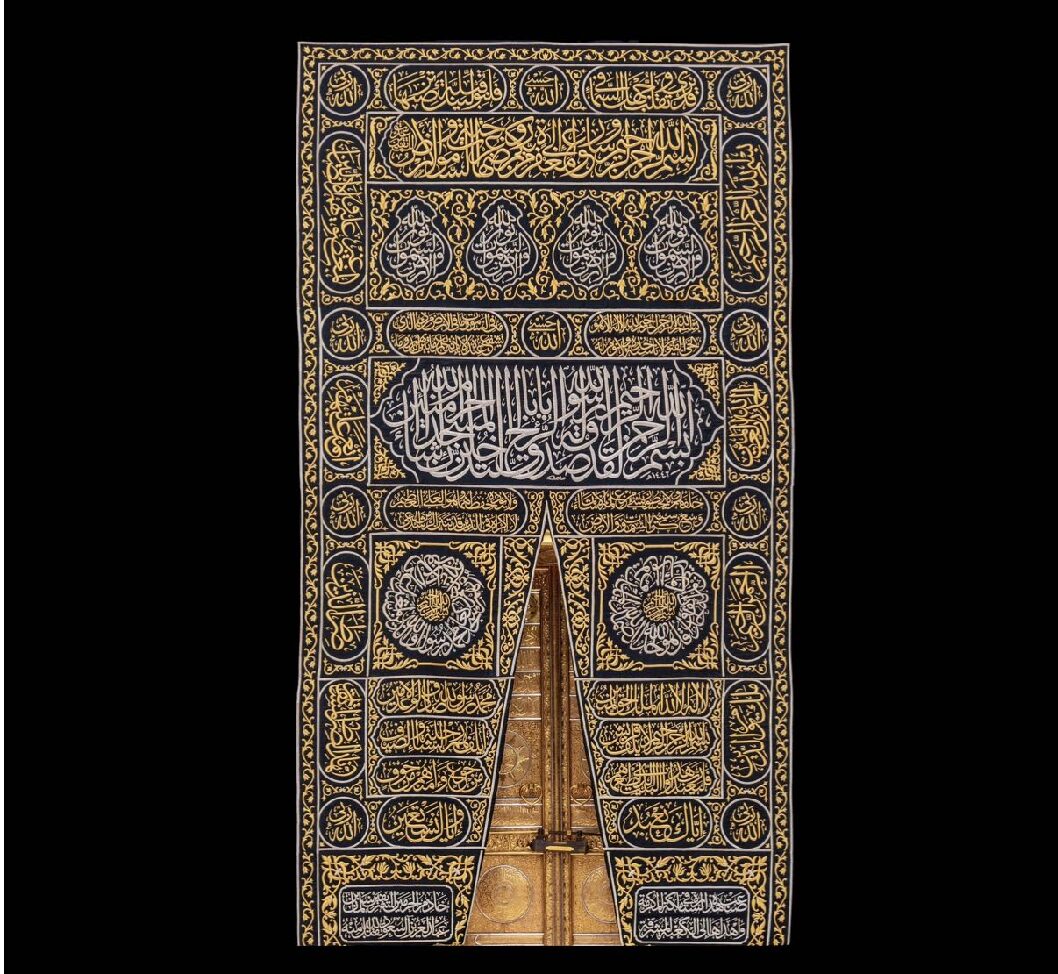


اترك تعليقاً